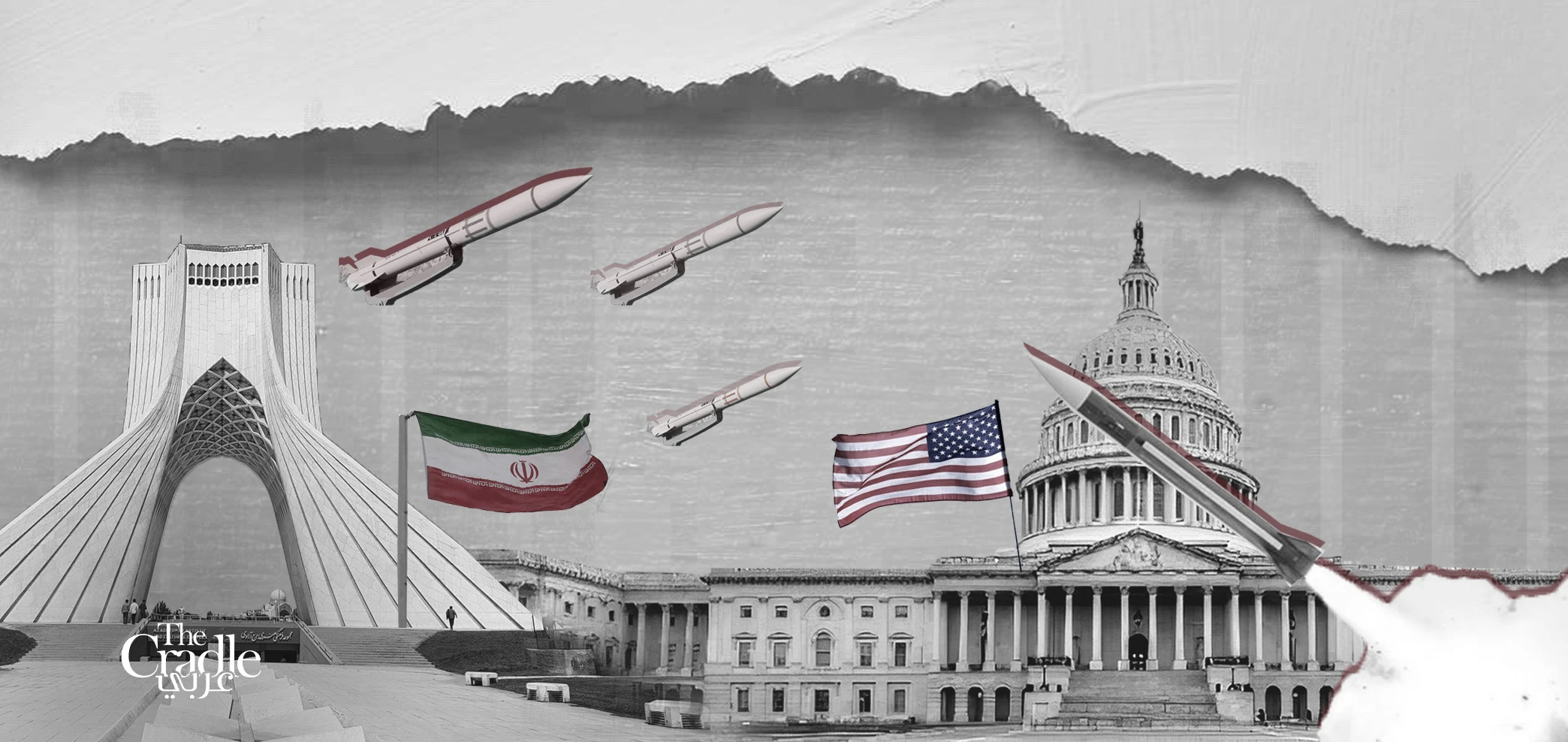
*عباس الزين
السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح اليوم لم يعد هل ستقع حرب بين إيران والولايات المتحدة؟ أو هل سيُبرم اتفاق شامل؟ بل أصبح كيف يدير الطرفان حافة التوتر؟
وما الحد الفاصل بين الضغط والتفجير؟
إذ في ظل اشتداد النار في غزة، وانفلات السلوك الإسرائيلي، وتضارب أجندات القوى الدولية، باتت المفاوضات بين واشنطن وطهران مساحة محمّلة بالتناقضات، توازي فيها الرغبة في الاتفاق الحاجة إلى التهديد، ويوازي فيها الخوف من الحرب استخدام أدواتها كأوراق تفاوضية.
هذه ليست مفاوضات عادية ضمن جولات مباحثات بعناوين واضحة وملموسة، فهي لا تدور فقط حول تخصيب اليورانيوم والملف النووي الإيراني، بل تشمل أيضًا حدود الحضور الإيراني في الإقليم، وعلاقة طهران بحركات المقاومة، وطبيعة التموضع الإسرائيلي داخل معادلة الردع من جهة.
ومن جهة أخرى حدود الدور الامريكي في إدارة خرائط الصراع، وفي الشراكة والتغطية الامريكيتين للقوة الإسرائيلية في المنطقة، وأيضاً قدرة الولايات المتحدة على الموازنة في عهد ترامب بين مصالحها الاقتصادية والمالية وعلاقاتها الإقليمية وبين الحفاظ على هيمنتها الجيوسياسية.
وفق الولايات المتحدة فإن الظروف الحالية تجعل من التفاوض قناة أكثر جدوى للضغط على طهران. المقاربة الامريكية ترى أن إيران ونتيجة التطورات في العامين الماضيين تعيش حاليًا وضعًا يمكن استغلاله لدفعها إلى تقديم تنازلات، ليس فقط فيما يتعلق ببرنامجها النووي، بل أيضًا بما يخص حضورها الإقليمي، وخصوصًا دعمها لحركات المقاومة وموقعها في المعادلة الفلسطينية ومواجهتها المفتوحة مع "إسرائيل".
وعليه، فإن واشنطن لا تدخل التفاوض بلغة تفاهم، بل بلغة تهديد مدروسة. في المقابل، إيران لا تدخل هذا المسار من موقع خضوع، بل من موقع مقاومة مشروطة. فطهران ترى في المفاوضات وسيلة لرفع العقوبات واستعادة حقها في امتلاك برنامج نووي سلمي. لكنها لا تفصل هذا المسار عن مسار موازٍ، يتمثل بفرض توازنات إقليمية جديدة تكبح العدوان الإسرائيلي وتردع العربدة المدعومة امريكيًا.
مناقشة احتمال نجاح التفاوض أو انهياره لا تنفصل عن فهم أدوات الضغط المتبادلة التي يستخدمها كل طرف، لا من أجل تحقيق التهدئة فقط، بل لفرض قواعد اشتباك جديدة. وفي ظل ميزان متوتر كهذا، يبدو الاتفاق مشروطًا بمدى قدرة كل طرف على مراكمة أوراقه، أكثر مما هو مشروط بإرادة الحل. وبين السقف الامريكي العالي برفض أي تخصيب لليورانيوم في إيران، وبين الخط الأحمر الإيراني الذي يؤكد أن هذا التخصيب غير قابل للتفاوض أساساً، تظهر خرائط الضغط التي يستخدمها الطرفان.
الولايات المتحدة وأدواتها الإسرائيلية والأوروبية
توظف الولايات المتحدة جملة من أدوات الضغط المتداخلة لإعادة تشكيل قواعد التفاوض مع إيران. من أبرز هذه الأدوات ما ظهر مؤخرًا على لسان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، حين أشار إلى أنه حذّر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من توجيه ضربة إلى إيران بسبب وجود مسار تفاوضي مفتوح.
إلا أن الرسالة التي التقطتها طهران لم تكن في مضمون التحذير، بل فيما بين السطور، والتي مضمونها أنه إذا تعثرت المفاوضات، فإن واشنطن لن تمانع إطلاق يد "إسرائيل" لتنفيذ ضربة نوعية ضد طهران. هذا التلويح لا يستهدف الردع بحد ذاته، بل يزرع في الوعي الإيراني فرضية دائمة بأن البديل عن الحوار هو التصعيد الإسرائيلي بضوء أخضر امريكي، أو مشاركة امريكية، ما يجعل من "إسرائيل" ذراعًا ضغطية متقدمة ضمن منظومة امريكية أكبر.
في السياق ذاته، تتحول الحرب على غزة إلى أداة ضغط إقليمية على إيران التي لطالما عبّرت عن أن أولوياته هي وقف هذه الحرب. وواشنطن، عبر دعمها غير المشروط للآلة العسكرية الإسرائيلية، تفتح المجال أمام مزيد من الشراسة الميدانية، وتُغطي سياسيًا مسارًا يُراد له أن يكون رسالة إلى إيران، بأن توقف الحرب مرتبط بالتنازلات التي يمكن أن تقدمها في ملفات معينة، أو أن الحرب الإقليمية التي كانت إيران تحذّر منها انطلاقاً من استمرار حرب غزة، ستسير بها واشنطن بنفسها. لذلك، فإن انقلاب المبعوث الامريكي ستيف ويتكوف على اتفاقاته مع حماس من خلال الورقة التي قدمها، مرتبط بتعقيدات المفاوضات الإيرانية الامريكية أيضاً بنسبة معينة. وهنا لا تكون غزة مجرد ساحة حرب، بل واجهة للضغط على الحلفاء، ومنصة لتضييق الهامش الاستراتيجي الإيراني.
أما في لبنان، تحوّلت المعادلة إلى غطاء استباقي محتمل لأي توسّع في الضربات الإسرائيلية. فالموقف الامريكي الأخير الذي برر الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ودعمها، يُظهر تحوّلًا نوعيًا، من إدارة النزاع بما يضمن مصالح الاحتلال إلى تدخل مباشر لصالح الاحتلال، باعتبار أن الحديث الامريكي الذي دعم العدوان الإسرائيلي الأكبر من نوعه منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، كان سابقة في وضوحه، لا سيما وأن "إسرائيل" أصرًت على القول هذه المرة إنه تم بعلم مسبق امريكي. ما يفتح الباب أمام استخدام الجبهة اللبنانية كورقة ضغط تفاوضية امريكية غير مباشرة على إيران.
وبموازاة هذه الجبهات، تواصل واشنطن استثمار أدواتها الاقتصادية والسياسية لزيادة الخناق على إيران. العقوبات لا تزال تطال معظم القطاعات الحيوية، من الطاقة إلى النظام المصرفي، لكنها تُستكمل الآن بما يُعرف بـ"آلية الزناد" أو Snapback، التي تدفع بها الترويكا الأوروبية، بتحفيز امريكي واضح، لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران من دون المرور بمجلس الأمن.
وبما أن هذا الأمر يجب أن يمر عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبار أنها "ستنفي التزام إيران بالاتفاق النووي"، فإن الأخيرة استبقت هذا الأمر ضمن مسار المفاوضات قبل صدور قرار الوكالة ضدها، حيث أبلغت الولايات المتحدة، عبر وسطاء، أنّ أيّ قرار يصدر عن الوكالة ضدّ برنامجها النووي، لن يُنظر إليه على أنه خطوة أوروبية فحسب، "بل ستحمل واشنطن أيضاً مسؤولية تبعاته". كما أوضحت للجانب الامريكي أنّ "ردّها على أيّ تصعيد من الوكالة سيترك أثراً مباشراً على مسار المحادثات غير المباشرة الجارية".
العقيدة الدفاعية لإيران والتهديدات الهجومية
إيران لا تدخل المفاوضات من موقع ضعف أو خضوع، بل من موقع استثمار مدروس لأوراق ردع وضغط تمتلكها، وتستخدمها بمرونة سياسية تحاكي تصاعد التهديدات المحيطة بها. الرسائل الصادرة من طهران واضحة لا لبس فيها، بأن أي هجوم مباشر عليها لن يبقى محصورًا داخل حدودها، بل سيشعل جبهات متعددة في الإقليم. ليس لأن إيران تسعى لتوسيع المواجهة، بل لأنها تعتبر أن طبيعة تموضع القوات الامريكية في المنطقة، من القواعد العسكرية في الخليج إلى الانتشار البحري، يجعل المصالح الامريكية مكشوفة ومعرّضة لمخاطر لا يمكن احتواؤها. والأساس في هذا التهديد لا يعود فقط إلى القدرة الصاروخية أو العسكرية الإيرانية، بل إلى معادلة أكثر تعقيدًا، تتعلق بالاستقرار الذي تحتاجه واشنطن لتأمين تدفق الطاقة والتجارة في غرب آسيا، بالتوازي مع المشاريع الاقتصادية الهائلة التي أبرمها ترامب مع الخليج في زيارته الأخيرة والتي لا يمكن أن تتم تحت "الباليستي" الإيراني العابر للأجواء.
وفيما يخص "إسرائيل"، فإن التحذير الإيراني من طبيعة الرد عليها، لا يندرج ضمن خطاب تعبوي بل ضمن معادلة ردع حقيقية. طهران لمّحت إلى أن الضربة التي قد تُوجه للمصالح الامريكية أو الإسرائيلية لن تكون كسابقاتها من حيث التوقيت أو النطاق أو الشدة. بل إنها ستكون ردًا نوعيًا، يستهدف تغيير قواعد اللعبة لا مجرد تسجيل موقف. وفي هذا الإطار، لا يبدو أن إيران تكتفي بردود غير مركزية، بل تفتح الباب على إمكانية ضربة مباشرة تقلب الموازين، بما يشمل البنية التحتية العسكرية والاقتصادية في الكيان الإسرائيلي. يأتي ذلك بينما تؤكّد طهران أنّ الوثائق التي حصلت عليها الاستخبارات الإيرانية حول مشاريع الاحتلال الإسرائيلي ومنشآته النووية "تعزز القدرة الهجومية للبلاد"، وهذا فيه إشارة واضحة إلى طبيعة الرد المحتمل، في الوقت الذي أوضح فيه المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن "بنك أهداف الكيان الصهيوني باتت على طاولة القوات المسلحة الإيرانية".
وفي السياق، فإن إيران لا تفاوض فقط انطلاقًا من مصالحها المباشرة، بل تسعى أيضًا إلى تحييد الساحات التي تُستخدم اليوم ضدها. من منظور طهران، التفاوض هو مسعى لحماية حلفائها بقدر ما هو دفاع عن سيادتها. غزة ولبنان، اللتان تحاول واشنطن توظيف تصعيدهما كأداتي ضغط على إيران، تتحولان في مقاربة طهران إلى خطوط أمامية، تتطلب فرض مظلة سياسية تلزم واشنطن بكبح جماح "إسرائيل" ووقف استباحة هذه الساحات. بكلام آخر، فإن إنجاح التفاوض لا يمكن فصله عن تحقيق حدّ أدنى من الاستقرار الإقليمي، الذي تحتاجه واشنطن. أي أن إيران تعمل على عكس اتجاه الضغط، بدل أن تكون غزة ولبنان أوراقًا امريكية ضدها، تسعى لأن تتحولا إلى التزام امريكي ضد التصعيد الإسرائيلي، كجزء من أثمان التسوية.
أما الورقة الأخطر بيد طهران، فلا تزال تتمثل في موقعها النووي كأداة ردع استراتيجية. لطالما أكدت القيادة الإيرانية أن برنامجها النووي يرتبط بملفاتها الحيوية الاقتصادية والخدماتية، وأن العقيدة الدفاعية للنظام لا تشمل تطوير سلاح نووي، مستندة إلى فتوى دينية تُحرّمه، وعقيدة دفاعية لا حاجة فيها لسلاح نووي. لكن هذا التأكيد لا يُغلق الباب أمام سيناريوات مستقبلية. إذ تلوّح إيران، ولو ضمنيًا، بأن تغير طبيعة التهديد قد يفرض مراجعة للعقيدة الدفاعية. وإذا رأت القيادة أن النظام برمته مهدد وجوديًا، فقد يصبح تعديل تفسير الفتوى خيارًا متاحًا، أي أن تغيير العقيدة الدفاعية سيكون نتيجة لتغيير التهديدات الهجومية.
هكذا، يتحول التخصيب من أداة تفاوضية إلى مظلة ردع معلّقة، لا تُستخدم إلا إذا سُدّت كل المنافذ الأخرى، لا سيما مع قرار الوكالة الذرية الدولية الذي يتحدث عن "فشل" إيراني في التعاون معها، ويشير إلى أن "الوكالة غير قادرة على التحقق من عدم حدوث تحويل للمواد النووية المطلوب ضمانها إلى أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية". وكانت طهران قد مررت رسالة مفادها أن "أيّ محاولة غربية لاستغلال تقارير الوكالة في مجلس الأمن الدولي ستؤدّي إلى تغيير كامل في المعادلات المرتبطة بالملف النووي الإيراني".
ما هي جدوى أدوات الضغط
مقاربة واشنطن التي تمزج بين التهديد والدبلوماسية تعكس مبدأ "الردع بالوكالة"، بينما طهران تعتمد استراتيجية المرونة الصلبة (flexible deterrence) التي تجمع بين التلويح برد نوعي، والاحتفاظ بمسار تفاوضي مفتوح، وهذا ما يجعل المسار التفاوضي هشًا، لكنه ليس معدوم الفرص. لذا، فإن احتمالات نجاح المفاوضات ممكنة. الطرفان لا يبحثان عن حرب شاملة، بل يديران صراعًا مركبًا يتداخل فيه التفاوض مع القوة وهذا طبيعي. ووجود موازين ردع متبادلة يفرض على كلا الجانبين التفكير في التسويات، لا لأن الثقة متوفرة، بل لأن البدائل أكثر كلفة وتعقيدًا.
الحرب المستمرة على غزة، وما تتضمنه من مجازر تُرتكب يوميًا، تجري تحت غطاء سياسي امريكي واضح، وتحوّلت إلى عنوان دائم للانفجار لأن تداعيات هذه الحرب أثقل من أن يتجاوزها مستقبل المنطقة. هذا الواقع لا يشكل عبئًا إنسانيًا فقط، بل يرسم حدودًا جديدة للتفاوض، فلا يمكن أن تُبنى أي تسوية مع طهران في الوقت الذي يُستخدم فيه حلفاؤها كورقة ضغط ميداني على طاولة التفاوض نفسها، أو يتم ابتزازها بما قامت عليه ثورتها ونظامها، وهو دعم القضية الفلسطينية وحركات المقاومة. في المقابل، تجد الإدارة الامريكية نفسها محاصرة بمعادلة حرجة، من جهة تريد استقرارًا نسبيًا يخدم مصالحها الاقتصادية والمالية في المنطقة والتي وضعها ترامب كأولوية، لكنها غير مستعدة للضغط بجدية على "إسرائيل" لفرض هذا الاستقرار. وهذه المفارقة تُضعف قدرة واشنطن على إنجاح أي اتفاق بعيد المدى.
تتجاوز المواجهة بين واشنطن وطهران كونها صراعًا تقليديًا بين دبلوماسية وعقوبات، أو تفاوض وتصعيد، لتغدو معركة معقّدة تُدار على حافة الخطر، ويتداخل فيها العسكري بالسياسي، والإقليمي بالعالمي. ما يجري ليس سباقًا نحو اتفاق نووي فحسب، بل اختبارٌ شامل لإرادة الهيمنة الامريكية وممانعة المشروع الإيراني المناهض لها. وطالما أن أدوات الدبلوماسية لكلا الطرفين الإيراني والامريكي، هي ذاتها أدوات الحرب، فإن التسويات ستبقى رهينة حسابات القوة لا المنطق التفاوضي، لتصبح، إما دخولاً في الحرب أو استعداداً لها كمعركة مؤجلة.
*The Cradle Arabic