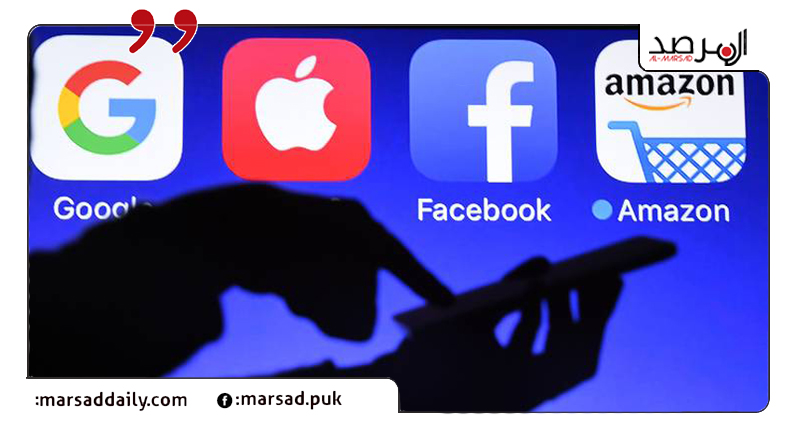
فرانسيس فوكوياما وباراك ريتشمان وأشيش جويل
*مجلة فورين افيرز/الترجمة والتحرير:المرصد
من بين التحولات العديدة التي تحدث في الاقتصاد الأمريكي، لا يوجد شيء أكثر بروزًا من نمو منصات الإنترنت العملاقة.
أصبحت Amazon و Apple و Facebook و Google و Twitter، التي كانت قوية بالفعل قبل جائحة COVID-19، أكثر قوة أثناء ذلك، حيث تنتقل الكثير من الحياة اليومية عبر الإنترنت.
على الرغم من ملاءمة تقنيتهم ، فإن ظهور مثل هذه الشركات المهيمنة يجب أن يدق أجراس الإنذار - ليس فقط لأنهم يتمتعون بقدر كبير من القوة الاقتصادية ولكن أيضًا لأنهم يمارسون قدرًا كبيرًا من السيطرة على الاتصالات السياسية.
تهيمن هذه الشركات العملاقة الآن على نشر المعلومات وتنسيق التعبئة السياسية.
وهذا يشكل تهديدات فريدة لديمقراطية تعمل بشكل جيد.
بينما سعى الاتحاد الأوروبي إلى إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار ضد هذه المنصات، كانت الولايات المتحدة فاترة أكثر في استجابتها.
لكن هذا بدأ يتغير. على مدار العامين الماضيين، بدأت لجنة التجارة الفيدرالية وائتلاف من المدعين العامين للولاية تحقيقات في الانتهاكات المحتملة لسلطة احتكار هذه المنصات، وفي تشرين الأول (أكتوبر)، رفعت وزارة العدل دعوى ضد Google ضد الاحتكار.
يشمل منتقدو Big Tech الآن كلا من الديمقراطيين الذين يخشون التلاعب من قبل المتطرفين المحليين والأجانب والجمهوريين الذين يعتقدون أن المنصات الكبيرة متحيزة ضد المحافظين.
في غضون ذلك، تسعى حركة فكرية متنامية، بقيادة زمرة من علماء القانون المؤثرين، إلى إعادة تفسير قانون مكافحة الاحتكار لمواجهة هيمنة المنصات.
على الرغم من وجود إجماع ناشئ حول التهديد الذي تشكله شركات التكنولوجيا الكبرى على الديمقراطية، إلا أنه لا يوجد اتفاق يذكر حول كيفية الرد.
جادل البعض بأن الحكومة بحاجة إلى تفكيك فيسبوك وجوجل. ودعا آخرون إلى لوائح أكثر صرامة للحد من استغلال هذه الشركات للبيانات.
بدون طريقة واضحة للمضي قدمًا، تخلف العديد من النقاد عن الضغط على المنصات للتنظيم الذاتي، وتشجيعهم على إزالة المحتوى الخطير والقيام بعمل أفضل في تنظيم المواد المنقولة على مواقعهم.
لكن قلة هم الذين يدركون أن الأضرار السياسية التي تسببها المنصات أكثر خطورة من الأضرار الاقتصادية. قلة هم الذين فكروا في طريقة عملية للمضي قدمًا: التخلص من دور المنصات كحراس للمحتوى.
يستلزم هذا النهج دعوة مجموعة جديدة من شركات "البرامج الوسيطة" التنافسية لتمكين المستخدمين من اختيار كيفية تقديم المعلومات إليهم. ومن المرجح أن يكون أكثر فاعلية من جهد خيالي لتفكيك هذه الشركات.
قوة المنصة
تعود جذور قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي المعاصر إلى السبعينيات، مع ظهور اقتصاديي السوق الحرة والباحثين القانونيين.
ظهر روبرت بورك، الذي كان محاميًا عامًا في منتصف السبعينيات، كباحث بارز جادل في أن قانون مكافحة الاحتكار يجب أن يكون له هدف واحد فقط: تعظيم رفاهية المستهلك.
وجادل بأن السبب وراء نمو بعض الشركات بهذه الضخامة هو أنها كانت أكثر كفاءة من منافسيها، وبالتالي فإن أي محاولات لتفكيك هذه الشركات كانت مجرد معاقبة لها على نجاحها.
تم إعلام معسكر العلماء هذا من خلال نهج عدم التدخل لما يسمى بمدرسة شيكاغو للاقتصاد، بقيادة الحائزين على جائزة نوبل ميلتون فريدمان وجورج ستيجلر، اللذان ينظران إلى التنظيم الاقتصادي بشك.
جادلت مدرسة شيكاغو أنه إذا كان يجب هيكلة قانون مكافحة الاحتكار لتحقيق أقصى قدر من الرفاهية الاقتصادية، فيجب أن يكون منضبطًا للغاية.
بكل المقاييس، حققت هذه المدرسة الفكرية نجاحًا مذهلاً، حيث أثرت على أجيال من القضاة والمحامين وتولت السيطرة على المحكمة العليا.
تبنت وزارة العدل في إدارة ريغان وقننت العديد من مبادئ مدرسة شيكاغو، واستقرت سياسة مكافحة الاحتكار الأمريكية إلى حد كبير على نهج متساهل منذ ذلك الحين.
بعد عقود من هيمنة مدرسة شيكاغو، أتيحت للاقتصاديين فرصة كبيرة لتقييم آثار هذا النهج.
ما وجدوه هو أن الاقتصاد الأمريكي نما بشكل مطرد أكثر تركيزًا في جميع المجالات - في شركات الطيران وشركات الأدوية والمستشفيات والمنافذ الإعلامية، وبالطبع شركات التكنولوجيا - وقد عانى المستهلكون.
ويربط الكثيرون، مثل توماس فيليبون، صراحةً بين الأسعار المرتفعة في الولايات المتحدة، مقارنةً بتلك الموجودة في أوروبا، وبين عدم كفاية تطبيق مكافحة الاحتكار.
الآن، تجادل "مدرسة ما بعد شيكاغو" المتنامية بأن قانون مكافحة الاحتكار يجب أن يتم تطبيقه بقوة أكبر.
ويعتقدون أن تطبيق مكافحة الاحتكار ضروري لأن الأسواق غير المنظمة لا يمكنها أن توقف صعود الاحتكارات المانعة للمنافسة وترسيخها.
أدت أوجه القصور في نهج مدرسة شيكاغو لمكافحة الاحتكار أيضًا إلى "مدرسة نيو برانديزيان" لمكافحة الاحتكار.
تجادل هذه المجموعة من الباحثين القانونيين بأن قانون شيرمان، أول قانون فيدرالي لمكافحة الاحتكار في البلاد، كان يهدف إلى حماية ليس فقط القيم الاقتصادية ولكن أيضًا القيم السياسية، مثل حرية التعبير والمساواة الاقتصادية.
نظرًا لأن المنصات الرقمية تمارس قوة اقتصادية وتتحكم في اختناقات الاتصالات، فقد أصبحت هذه الشركات هدفًا طبيعيًا لهذا المعسكر.
صحيح أن الأسواق الرقمية تعرض سمات معينة تميزها عن التقليدية. لسبب واحد، عملة العالم هي البيانات.
بمجرد أن تجمع شركة مثل Amazon أو Google بيانات عن مئات الملايين من المستخدمين، يمكنها الانتقال إلى أسواق جديدة تمامًا والتغلب على الشركات القائمة التي تفتقر إلى المعرفة المماثلة.
لشيء آخر، تستفيد هذه الشركات بشكل كبير مما يسمى تأثيرات الشبكة.
كلما زاد حجم الشبكة، أصبحت أكثر فائدة لمستخدميها، مما يخلق حلقة ردود فعل إيجابية تقود شركة واحدة للسيطرة على السوق.
على عكس الشركات التقليدية، لا تتنافس الشركات في الفضاء الرقمي على حصتها في السوق ؛ يتنافسون على السوق نفسه.
يستطيع المحركون الأولون ترسيخ أنفسهم وجعل المزيد من المنافسة مستحيلة. يمكنهم ابتلاع المنافسين المحتملين، كما فعل Facebook من خلال شراء Instagram و WhatsApp.
لكن هيئة المحلفين لا تزال خارج السؤال حول ما إذا كانت شركات التكنولوجيا الضخمة تقلل من رفاهية المستهلك.
إنهم يقدمون ثروة من المنتجات الرقمية، مثل عمليات البحث والبريد الإلكتروني وحسابات الشبكات الاجتماعية، ويبدو أن المستهلكين يقدرون هذه المنتجات بدرجة عالية، حتى عندما يدفعون ثمنًا بالتخلي عن خصوصيتهم والسماح للمعلنين باستهدافها.
علاوة على ذلك، يمكن الدفاع في نفس الوقت عن كل إساءة استخدام تتهم هذه المنصات بارتكابها باعتبارها فعالة اقتصاديًا.
على سبيل المثال، أغلقت أمازون متاجر التجزئة التابعة للأمهات والبوب وألحقت أضرارًا ليس بالشوارع الرئيسية فحسب، بل أيضًا بائعي التجزئة الكبار.
لكن الشركة تقدم في الوقت نفسه خدمة يجدها العديد من المستهلكين لا تقدر بثمن. (تخيل كيف سيكون الأمر إذا اضطر الناس إلى الاعتماد على البيع بالتجزئة شخصيًا أثناء الوباء.) أما بالنسبة للادعاء بأن المنصات تشتري الشركات الناشئة لمنع المنافسة، فمن الصعب معرفة ما إذا كانت شركة شابة ستصبح Apple التالية أو لو ظلت Google مستقلة، أو إذا كانت ستفشل دون ضخ رأس المال والخبرة الإدارية التي تلقتها من مالكيها الجدد. على الرغم من أنه كان من الممكن أن يكون المستهلكون أفضل حالًا إذا ظل Instagram منفصلاً وأصبح بديلاً قابلاً للتطبيق لـ Facebook، إلا أنهم كانوا سيصبحون أسوأ حالًا إذا فشل Instagram تمامًا.
إن الحجة الاقتصادية لكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبيرة معقدة. لكن هناك قضية سياسية أكثر إقناعًا. تتسبب منصات الإنترنت في أضرار سياسية أكثر إثارة للقلق من أي ضرر اقتصادي تسببه. إن الخطر الحقيقي ليس في تشويه الأسواق ؛ إنهم يهددون الديمقراطية.
احتكار المعلومات
منذ عام 2016، استيقظ الأمريكيون على قوة شركات التكنولوجيا في تشكيل المعلومات. سمحت هذه المنصات للمخادعين بنشر الأخبار المزيفة والمتطرفين لدفع نظريات المؤامرة.
لقد أنشأوا "فقاعات التصفية"، وهي بيئة يتعرض فيها المستخدمون، بسبب طريقة عمل الخوارزميات الخاصة بهم، فقط للمعلومات التي تؤكد معتقداتهم الموجودة مسبقًا.
ويمكنهم تضخيم أصوات معينة أو دفنها، وبالتالي يكون لها تأثير مزعج على النقاش السياسي الديمقراطي. الخوف النهائي هو أن المنصات قد جمعت الكثير من القوة بحيث يمكنها التأثير في الانتخابات، إما عن قصد أو عن غير قصد.
استجاب النقاد لهذه المخاوف من خلال مطالبة المنصات بتحمل مسؤولية أكبر عن المحتوى الذي تبثه.
ودعوا تويتر إلى قمع أو التحقق من صحة تغريدات الرئيس دونالد ترامب المضللة. لقد انتقدوا فيسبوك لقوله إنه لن يعمل على تعديل المحتوى السياسي.
يود الكثيرون رؤية منصات الإنترنت تتصرف مثل الشركات الإعلامية، وتنظم محتواها السياسي وتحاسب المسؤولين الحكوميين.
لكن الضغط على المنصات الكبيرة لأداء هذه الوظيفة - على أمل أن تفعل ذلك مع مراعاة المصلحة العامة - ليس حلاً طويل المدى.
يتجنب هذا النهج مشكلة قوتهم الكامنة، وأي حل حقيقي يجب أن يحد من هذه القوة.
اليوم، يشكو المحافظون إلى حد كبير من التحيز السياسي لمنصات الإنترنت.
إنهم يفترضون، مع بعض التبرير، أن الأشخاص الذين يديرون منصات اليوم - جيف بيزوس من أمازون، ومارك زوكربيرغ من فيسبوك، وسوندار بيتشاي من جوجل، وجاك دورسي من تويتر - يميلون إلى أن يكونوا تقدميين اجتماعيًا، على الرغم من أنهم مدفوعون بشكل أساسي بالإعلانات التجارية المصلحة الذاتية.
لا يكمن الخطر الحقيقي لمنصات الإنترنت في أنها تشوه الأسواق ؛ إنهم يهددون الديمقراطية.
قد لا يصمد هذا الافتراض على المدى الطويل. لنفترض أن أحد هؤلاء العمالقة استولى عليه ملياردير محافظ. إن سيطرة روبرت مردوخ على Fox News و The Wall Street Journal يمنحه بالفعل نفوذاً سياسياً بعيد المدى، ولكن على الأقل تأثيرات هذا التحكم واضحة للعيان: أنت تعرف متى تقرأ افتتاحية في Wall Street Journal أو تشاهد Fox News. ولكن إذا كان مردوخ سيطر على Facebook أو Google، فيمكنه تغيير خوارزميات التصنيف أو البحث بمهارة لتشكيل ما يراه المستخدمون ويقرؤونه، مما قد يؤثر على آرائهم السياسية دون وعيهم أو موافقتهم.
وهيمنة المنصات تجعل من الصعب الهروب من تأثيرها. إذا كنت ليبراليًا، فيمكنك ببساطة مشاهدة MSNBC بدلاً من Fox ؛ في ظل موقع فيسبوك يسيطر عليه مردوخ، قد لا يكون لديك خيار مماثل إذا كنت ترغب في مشاركة القصص الإخبارية أو تنسيق النشاط السياسي مع أصدقائك.
ضع في اعتبارك أيضًا أن المنصات - Amazon و Facebook و Google، على وجه الخصوص - تمتلك معلومات حول حياة الأفراد لم يكن لدى المحتكرين السابقين.
إنهم يعرفون من هم أصدقاء الناس وعائلاتهم، ودخل الناس وممتلكاتهم، والعديد من التفاصيل الأكثر حميمية في حياتهم. ماذا لو استغل المسؤول التنفيذي لمنصة ذات نوايا فاسدة معلومات محرجة لفرض يد مسؤول عام؟ بدلاً من ذلك، تخيل إساءة استخدام المعلومات الخاصة بالاقتران مع سلطات الحكومة - على سبيل المثال، تعاون Facebook مع وزارة عدل مُسيَّسة.
إن القوة الاقتصادية والسياسية المركزة للمنصات الرقمية تشبه سلاحًا محشوًا يجلس على الطاولة.
في الوقت الحالي، من المحتمل ألا يحمل الأشخاص الجالسون على الجانب الآخر من الطاولة المسدس ويسحبوا الزناد.
ومع ذلك، فإن السؤال بالنسبة للديمقراطية الأمريكية هو ما إذا كان من الآمن ترك البندقية هناك، حيث يمكن لشخص آخر لديه نوايا أسوأ أن يأتي ويلتقطها.
لا توجد ديمقراطية ليبرالية تكتفي بتفويض سلطة سياسية مركزة للأفراد بناءً على افتراضات حول نواياهم الحسنة. لهذا السبب تضع الولايات المتحدة ضوابط وتوازنات على تلك القوة.
تضييق الخناق
الطريقة الأكثر وضوحا للتحقق من هذه السلطة هي التنظيم الحكومي.
هذا هو النهج المتبع في أوروبا، حيث أصدرت ألمانيا، على سبيل المثال، سن قانون يجرم نشر الأخبار المزيفة.
على الرغم من أن التنظيم قد يظل ممكنًا في بعض الديمقراطيات بدرجة عالية من الإجماع الاجتماعي، فمن غير المرجح أن ينجح في بلد مستقطب مثل الولايات المتحدة.
بالعودة إلى ذروة البث التلفزيوني، تطلب مبدأ العدالة للجنة الاتصالات الفيدرالية من الشبكات الحفاظ على تغطية "متوازنة" للقضايا السياسية.
هاجم الجمهوريون العقيدة بلا هوادة، مدعين أن الشبكات كانت متحيزة ضد المحافظين، وألغتها لجنة الاتصالات الفيدرالية في عام 1987.
لذلك تخيل منظمًا عامًا يحاول أن يقرر ما إذا كان سيتم حظر تغريدة رئاسية اليوم. مهما كان القرار، سيكون مثيرًا للجدل على نطاق واسع.
هناك طريقة أخرى للتحقق من قوة منصات الإنترنت وهي الترويج لمنافسة أكبر.
إذا كان هناك العديد من المنصات، فلن يتمتع أي منها بالهيمنة التي يتمتع بها Facebook و Google اليوم.
ومع ذلك، تكمن المشكلة في أنه لا يمكن للولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي على الأرجح تفكيك Facebook أو Google بالطريقة التي تم بها تفكيك Standard Oil و AT&T.
ستقاوم شركات التكنولوجيا اليوم بشدة مثل هذه المحاولة، وحتى لو خسرت في النهاية، فإن عملية تفكيكها ستستغرق سنوات، إن لم يكن عقودًا، حتى تكتمل.
ربما الأهم من ذلك، أنه ليس من الواضح ما إذا كان كسر Facebook، على سبيل المثال، من شأنه أن يحل المشكلة الأساسية.
هناك فرصة جيدة جدًا أن ينمو طفل Facebook الذي تم إنشاؤه بواسطة مثل هذا التفكك بسرعة ليحل محل الوالدين. حتى AT&T استعادت هيمنتها بعد تفككها في الثمانينيات. إن قابلية التوسع السريع لوسائل التواصل الاجتماعي تجعل ذلك يحدث بشكل أسرع.
في ضوء الاحتمالات القاتمة للانفصال، تحول العديد من المراقبين إلى "قابلية نقل البيانات" لإدخال المنافسة في سوق المنصة.
مثلما تطلب الحكومة من شركات الهاتف السماح للمستخدمين بأخذ أرقام هواتفهم معهم عندما يغيرون الشبكات، فقد يفرض ذلك على المستخدمين الحق في نقل البيانات التي قاموا بتسليمها من منصة إلى أخرى.
اعتمدت اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، قانون الخصوصية القوي في الاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في 2018، هذا النهج بالذات، والذي يفرض تنسيقًا قياسيًا يمكن قراءته آليًا لنقل البيانات الشخصية.
ومع ذلك، تواجه قابلية نقل البيانات عددًا من العقبات. أهمها صعوبة نقل أنواع كثيرة من البيانات.
على الرغم من سهولة نقل بعض البيانات الأساسية - مثل اسم الشخص وعنوانه ومعلومات بطاقة الائتمان وعنوان البريد الإلكتروني - فسيكون نقل جميع البيانات الوصفية للمستخدم أكثر صعوبة.
تتضمن البيانات الوصفية إبداءات الإعجاب والنقرات والأوامر وعمليات البحث وما إلى ذلك.
هذه الأنواع من البيانات بالتحديد هي القيمة في الإعلان المستهدف.
ليس فقط ملكية هذه المعلومات غير واضحة ؛ المعلومات نفسها هي أيضًا غير متجانسة وذات نظام أساسي محدد.
كيف بالضبط، على سبيل المثال، يمكن نقل سجل عمليات البحث السابقة على Google إلى نظام أساسي جديد يشبه Facebook؟
تعتمد طريقة بديلة لكبح قوة المنصات على قانون الخصوصية.
بموجب هذا النهج، ستحد اللوائح من الدرجة التي يمكن أن تستخدم بها شركة التكنولوجيا بيانات المستهلك التي يتم إنشاؤها في قطاع ما لتحسين وضعها في قطاع آخر، وحماية الخصوصية والمنافسة.
على سبيل المثال، يتطلب القانون العام لحماية البيانات (GDPR) استخدام بيانات المستهلك فقط للغرض الذي تم الحصول على المعلومات من أجله في الأصل، ما لم يمنح المستهلك إذنًا صريحًا بخلاف ذلك. تم تصميم هذه القواعد لمعالجة أحد أكثر المصادر فاعلية لقوة النظام الأساسي: فكلما زادت البيانات الموجودة في النظام الأساسي، كان من الأسهل تحقيق المزيد من الإيرادات وحتى المزيد من البيانات.
لكن الاعتماد على قانون الخصوصية لمنع المنصات الكبيرة من دخول أسواق جديدة يطرح مشاكله الخاصة.
كما في حالة قابلية نقل البيانات، ليس من الواضح ما إذا كانت القواعد مثل اللائحة العامة لحماية البيانات تنطبق فقط على البيانات التي قدمها المستهلك طواعية إلى النظام الأساسي أم أيضًا على البيانات الوصفية.
وحتى إذا نجحت، فمن المرجح أن تقلل مبادرات الخصوصية من تخصيص الأخبار لكل فرد فقط، وليس تركيز القوة التحريرية.
على نطاق أوسع، من شأن هذه القوانين أن تغلق الباب على الحصان الذي غادر الحظيرة منذ فترة طويلة.
لقد جمعت عمالقة التكنولوجيا بالفعل كميات هائلة من بيانات العملاء. كما تشير الدعوى القضائية الجديدة لوزارة العدل، يعتمد نموذج أعمال Google على جمع البيانات الناتجة عن منتجاتها المختلفة - Gmail و Google Chrome وخرائط Google ومحرك البحث الخاص بها - والتي تتحد لتكشف عن معلومات غير مسبوقة عن كل مستخدم. قام Facebook أيضًا بجمع بيانات واسعة حول مستخدميه، جزئيًا من خلال الحصول على بعض البيانات عن المستخدمين أثناء تصفحهم لمواقع أخرى. إذا منعت قوانين الخصوصية المنافسين الجدد من تجميع واستخدام مجموعات بيانات مماثلة، فإنهم سيخاطرون ببساطة بتأمين مزايا هؤلاء المحركين الأوائل.
الحل الوسيط
إذا كانت كل من التنظيم والتفكك وإمكانية نقل البيانات وقانون الخصوصية قاصرة، فما الذي يجب فعله بشأن قوة النظام الأساسي المركزة؟
لم يحظ أحد أكثر الحلول الواعدة باهتمام كبير:
البرامج الوسيطة.
تُعرَّف البرامج الوسيطة عمومًا على أنها برمجيات تعمل فوق منصة موجودة ويمكنها تعديل عرض البيانات الأساسية. بالإضافة إلى خدمات منصات التكنولوجيا الحالية، يمكن أن تسمح البرمجيات الوسيطة للمستخدمين باختيار كيفية تنظيم المعلومات وتصفيتها لهم.
سيختار المستخدمون خدمات البرامج الوسيطة التي من شأنها تحديد أهمية وصحة المحتوى السياسي، وستستخدم المنصات هذه التحديدات لتنظيم ما شاهده هؤلاء المستخدمون.
بعبارة أخرى، ستتدخل طبقة تنافسية من الشركات الجديدة ذات الخوارزميات الشفافة وتتولى وظائف بوابة التحرير التي تشغلها حاليًا منصات التكنولوجيا المهيمنة التي تكون خوارزمياتها غير شفافة.
يمكن تقديم منتجات البرامج الوسيطة من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب.
يتمثل أحد الأساليب الفعالة بشكل خاص في وصول المستخدمين إلى البرامج الوسيطة عبر منصة تقنية مثل Apple أو Twitter. ضع في اعتبارك المقالات الإخبارية في خلاصات أخبار المستخدمين أو التغريدات الشائعة لشخصيات سياسية.
في خلفية Apple أو Twitter، يمكن أن تضيف خدمة البرامج الوسيطة تسميات مثل "مضللة" و "لم يتم التحقق منها" و "تفتقر إلى السياق".
عندما يقوم المستخدمون بتسجيل الدخول إلى Apple و Twitter، سيرون هذه العلامات على المقالات الإخبارية والتغريدات.
يمكن أن تؤثر البرامج الوسيطة الأكثر تدخلًا أيضًا على تصنيفات بعض الخلاصات، مثل قوائم منتجات Amazon أو إعلانات Facebook أو نتائج بحث Google أو توصيات فيديو YouTube.
على سبيل المثال، يمكن للمستهلكين اختيار موفري البرامج الوسيطة الذين قاموا بتعديل نتائج بحث Amazon الخاصة بهم لإعطاء الأولوية للمنتجات المصنوعة محليًا أو المنتجات الصديقة للبيئة أو السلع منخفضة السعر.
يمكن أن تمنع البرامج الوسيطة المستخدم من مشاهدة محتوى معين أو تمنع مصادر معلومات معينة أو الشركات المصنعة تمامًا.
سيُطلب من كل مزود للبرامج الوسيطة أن يكون شفافًا في عروضه وميزاته التقنية، حتى يتمكن المستخدمون من اتخاذ قرار مستنير.
سيشمل مقدمو البرامج الوسيطة كلتا الشركتين اللتين تسعى إلى تحسين الخلاصات والمنظمات غير الربحية التي تسعى إلى تعزيز القيم المدنية.
قد تقدم مدرسة الصحافة برمجيات وسيطة تفضل التقارير المتفوقة والقصص المكبوتة التي لم يتم التحقق منها، أو قد يقدم مجلس إدارة مدرسة المقاطعة برمجيات وسيطة تعطي الأولوية للقضايا المحلية.
من خلال التوسط في العلاقة بين المستخدمين والأنظمة الأساسية، يمكن أن تلبي البرامج الوسيطة تفضيلات المستهلكين الأفراد مع توفير مقاومة كبيرة للإجراءات أحادية الجانب للاعبين المهيمنين.
الكثير من التفاصيل لابد من العمل بها.
السؤال الأول هو مقدار قوة التنظيم التي يجب نقلها إلى الشركات الجديدة.
من ناحية أخرى، يمكن لمقدمي البرامج الوسيطة تحويل المعلومات المقدمة من النظام الأساسي الأساسي بالكامل إلى المستخدم، حيث تعمل المنصة على أنها أكثر بقليل من أنبوب محايد.
في ظل هذا النموذج، ستحدد البرامج الوسيطة وحدها محتوى وأولوية عمليات بحث Amazon أو Google، حيث توفر هذه الأنظمة الأساسية الوصول إلى خوادمها فقط.
على الجانب الآخر، يمكن للمنصة الاستمرار في تنظيم المحتوى وترتيبه بالكامل باستخدام خوارزمياتها الخاصة، وستعمل البرامج الوسيطة فقط كمرشح تكميلي. في ظل هذا النموذج، على سبيل المثال، ستظل واجهة Facebook أو Twitter دون تغيير إلى حد كبير. تقوم البرامج الوسيطة فقط بفحص الحقائق أو تسمية المحتوى دون إعطاء أهمية للمحتوى أو تقديم توصيات أكثر دقة.
ربما يكمن أفضل نهج في مكان ما بينهما. قد يعني تسليم الكثير من القوة لشركات البرمجيات الوسيطة أن منصات التكنولوجيا الأساسية ستفقد اتصالها المباشر بالمستهلك. مع تقويض نماذج أعمالهم، ستقاوم شركات التكنولوجيا.
من ناحية أخرى، فإن منح شركات برمجية وسيطة تحكمًا ضئيلًا للغاية قد يفشل في كبح قدرة المنصات على تنظيم المحتوى ونشره.
ولكن بغض النظر عن المكان المحدد بالضبط، فإن تدخل الحكومة سيكون ضروريًا.
من المحتمل أن يضطر الكونغرس إلى إصدار قانون يتطلب من المنصات استخدام واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة وموحدة، أو واجهات برمجة تطبيقات، والتي من شأنها أن تسمح لشركات البرامج الوسيطة بالعمل بسلاسة مع منصات تقنية مختلفة.
سيتعين على الكونغرس أيضًا أن ينظم بعناية موفري البرامج الوسيطة أنفسهم، بحيث يستوفون الحد الأدنى من معايير الموثوقية والشفافية والاتساق.
تتضمن المسألة الثانية إيجاد نموذج عمل من شأنه أن يحفز طبقة تنافسية من الشركات الجديدة على الظهور.
سيكون النهج الأكثر منطقية هو أن تقوم الأنظمة الأساسية المهيمنة ومقدمي البرامج الوسيطة من الأطراف الثالثة بإبرام اتفاقيات مشاركة الإيرادات.
عندما يقوم شخص ما بإجراء بحث على Google أو زيارة صفحة Facebook، ستتم مشاركة عائدات الإعلانات من الزيارة بين النظام الأساسي وموفر البرامج الوسيطة.
من المحتمل أن تخضع هذه الاتفاقيات للإشراف من قبل الحكومة، لأنه حتى لو كانت المنصات المهيمنة حريصة على مشاركة عبء تصفية المحتوى، يجب أن يُتوقع منها مقاومة مشاركة عائدات الإعلانات.
هناك تفصيل آخر يجب التوصل إليه وهو نوع من الإطار الفني الذي من شأنه أن يشجع على ظهور مجموعة متنوعة من منتجات البرمجيات الوسيطة.
يجب أن يكون إطار العمل بسيطًا بما يكفي لجذب أكبر عدد ممكن من الداخلين، ولكنه متطور بما يكفي ليلائم المنصات الكبيرة، ولكل منها هيكلها الخاص.
علاوة على ذلك، يجب أن تسمح للبرمجيات الوسيطة بتقييم ثلاثة أنواع مختلفة على الأقل من المحتوى: المحتوى العام الذي يمكن الوصول إليه على نطاق واسع (مثل القصص الإخبارية والبيانات الصحفية والتغريدات من الشخصيات العامة)، والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون (مثل مقاطع فيديو YouTube والتغريدات العامة من الأفراد) والمحتوى الخاص (مثل رسائل WhatsApp ومنشورات Facebook).
قد يجادل المشككون في أن نهج البرمجيات الوسيطة سيقسم الإنترنت ويعزز فقاعات التصفية.
على الرغم من أن الجامعات قد تطلب من طلابها استخدام منتجات برمجية وسيطة توجههم إلى مصادر موثوقة للمعلومات، فإن المجموعات ذات العقلية المؤامرة قد تفعل العكس.
قد تؤدي الخوارزميات المصممة خصيصًا إلى مزيد من الانقسام في النظام السياسي الأمريكي، وتشجع الناس على العثور على أصوات تعكس وجهات نظرهم، والمصادر التي تؤكد معتقداتهم، والقادة السياسيين الذين يضخمون مخاوفهم.
ربما يمكن حل بعض هذه المشكلات من خلال اللوائح التي تتطلب البرامج الوسيطة لتلبية الحد الأدنى من المعايير.
ولكن من المهم أيضًا ملاحظة أن مثل هذا الانقسام يمكن أن يحدث بالفعل، وقد يكون من المستحيل من الناحية التكنولوجية منع حدوثه في المستقبل. لنأخذ في الاعتبار المسار الذي سلكه أتباع QAnon، وهي نظرية مؤامرة يمينية متطرفة متقنة تفترض وجود عصابة عالمية للشذوذ الجنسي على الأطفال.
بعد تقييد المحتوى الخاص بهم بواسطة Facebook و Twitter، تخلى مؤيدو QAnon عن المنصات الكبيرة وانتقلوا إلى 4chan، وهي لوحة رسائل أكثر تساهلاً. عندما بدأت فرق الإشراف في 4chan في تلطيف التعليقات الحارقة، انتقل أتباع QAnon إلى منصة جديدة، 8chan (تسمى الآن 8kun).
لا يزال بإمكان منظري المؤامرة التواصل مع بعضهم البعض عبر البريد الإلكتروني العادي أو عبر القنوات المشفرة مثل Signal و Telegram و WhatsApp. مثل هذا الخطاب، مهما كان إشكاليًا، محمي بموجب التعديل الأول.
علاوة على ذلك، فإن الجماعات المتطرفة تعرض الديمقراطية للخطر في المقام الأول عندما تغادر محيط الإنترنت وتدخل إلى التيار الرئيسي.
يحدث هذا عندما يتم التقاط أصواتهم بواسطة الوسائط أو تضخيمها بواسطة منصة. على عكس 8chan، يمكن للمنصة المهيمنة التأثير على شريحة واسعة من السكان، ضد إرادة هؤلاء الأشخاص وبدون علمهم. على نطاق أوسع، حتى لو شجعت البرامج الوسيطة على الانقسام، فإن هذا الخطر يتضاءل مقارنةً بالخطر الذي تشكله قوة المنصة المركزة.
إن أكبر تهديد طويل الأمد للديمقراطية ليس تشتيت الرأي بل القوة غير الخاضعة للمساءلة التي تمارسها شركات التكنولوجيا العملاقة.
إعطاء السيطرة مرة أخرى
يجب أن ينزعج الجمهور من نمو وقوة منصات الإنترنت المهيمنة، وهناك سبب وجيه وراء تحول صانعي السياسات إلى قانون مكافحة الاحتكار كعلاج. لكن هذه ليست سوى واحدة من عدة ردود محتملة لمشكلة القوة الاقتصادية والسياسية الخاصة المركزة.
الآن، تطلق الحكومات إجراءات لمكافحة الاحتكار ضد منصات التكنولوجيا الكبيرة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، ومن المرجح أن يتم رفع الدعاوى القضائية الناتجة عن ذلك لسنوات قادمة.
لكن هذا النهج ليس بالضرورة أفضل طريقة للتعامل مع التهديد السياسي الخطير لقوة المنصة للديمقراطية.
تصوّر التعديل الأول سوقًا للأفكار حيث تحمي المنافسة، وليس التنظيم، الخطاب العام.
ومع ذلك، في عالم تضخم فيه المنصات الكبيرة الرسائل السياسية وتقمعها وتستهدفها، ينهار هذا السوق.
يمكن للبرمجيات الوسيطة معالجة هذه المشكلة. يمكن أن تأخذ هذه القوة بعيدًا عن منصات التكنولوجيا وتسليمها ليس إلى جهة تنظيمية حكومية واحدة ولكن إلى مجموعة جديدة من الشركات المنافسة التي من شأنها أن تسمح للمستخدمين بتكييف تجاربهم عبر الإنترنت.
لن يمنع هذا النهج خطاب الكراهية أو نظريات المؤامرة من الانتشار، ولكنه سيحد من نطاقها بطريقة تتماشى بشكل أفضل مع الهدف الأصلي للتعديل الأول.
اليوم، يتم تحديد المحتوى الذي تقدمه المنصات من خلال خوارزميات غامضة تم إنشاؤها بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي. باستخدام البرامج الوسيطة، سيتم تسليم مستخدمي النظام الأساسي عناصر التحكم. هم - وليس بعض برامج الذكاء الاصطناعي غير المرئية - سيقررون ما رأوه.
*فرانسيس فوكوياما: زميل أول في معهد فريمان سبوجلي للدراسات الدولية بجامعة ستانفورد.
*باراك ريشمان: هو أستاذ القانون في كاثرين بارتليت وأستاذ إدارة الأعمال في كلية الحقوق بجامعة ديوك.
*اشيش جيول :أستاذ علوم الإدارة والهندسة بجامعة ستانفورد.
*إنهم أعضاء في الفريق العامل المعني بمقياس النظام الأساسي لبرنامج جامعة ستانفورد حول الديمقراطية والإنترنت.